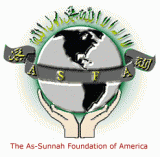بسم
الله الرحمن الرحيم
آفاق
الأساليب الصوفية
إعداد الدكتور أحمد عبد الرحيم السايح
إن لله سبحانه وتعالى نعما تطالع الناس صباحهم ومسائهم وتحيط بهم من فوقهم ومن تحتهم وعن أيمانهم وعن شمالهم. منها المنظور والمستور، والمعلوم والمجهول. تفيض عليهم بآثارها الملموسة في أنفسهم وفي آفاقهم. وفي طليعة هذه النعم التي أفاضها الحق تعالى على عباده نعمة الحياة والإيجاد، نعمة الخلق والإمداد والإعداد، مما غدا به الإنسان أعظم آية من آيات الله في خلقه، تشكل أروع أداة للدلالة على وجود الخالق البارئ المصور، وضرورة الإيمان به والاعتراف بفضله، ووجوب التوجه اليه وحده بما وجب من حقه في الإجلال والتقديس، وحتمية استشعار عظمته وسلطانه، وتعميق الخضوع له، والخشية منه، وتأكيد الحب فيه، والولاء له، ووجدان الأنس به، والاسترواح بذكره، والشوق الى لقائه، والسكينة إلى جواره. تلك هي العبادة الواجبة لله عز وجل. لايجد الإنسان كيانه إلا فيها، ولا امتداده إلا بها، ولاوجود إلا في الالتزام بها قولا وعملا، أمرا ونهيا، خلقا وسلوكا، واقعا وتطبيقا.. لقد غدا الإنسان للكون سيدا فلا أقل من أن يمضي لله عبدا، ولحق الله تابعا.
إن الوجود كله عابد بطبيعته، منصاع لوظيفته لا يسعه إلا أن يطيع في ولاء، لا يشوبه استنكاف، ولا يطاوله تأب، بل إنه جميعا من أعلاه إلى أسفله، يهتف في البداية من عالم الأزل بلغة المقهور أمام عظمة القاهر.. وهتاف العابد أمام قدسية المعبود بما سجله الحق في قوله ( ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين)
والإنسان- وإن كان يجاري الكون في العبادة بفطرته فإنه ينبغي عليه أن يفوقه في العبادة منزلة، وأن يعلوه فيها درجات تتناسب وحقيقة الفرد، وتكوينه المتميز بالعقل والإرادة والاختيار والميول والنزعات والرغائب. وأن يكون لهذه العبادة الاختيارية نمطها الخاص الذي يواكب الفطرة. أن العبادة حق الله على عباده، ما خلقهم الله إلا لها، ولا يرضى عنهم إلا بها. وما زاولوها، ومارسوا شعائرها في إخبات وخشوع، وفي تذلل وخضوع، وخوف منه، يشفعه الرجاء، وتضرع إليه يحدوه الأمل، وعرفانا له بحقه عليهم وواجبهم نحوه، مستبقين في حلبته، مسارعين إلى خيره.. إلا أبدلهم الله من الضيق فرجا، ومن الشدة مخرجا، ومن القلق اطمئنانا، ومن الخوف أمنا، ثم غفر زلتهم، وأقال عثرتهم، وقبل أوبتهم، ورحم ضعفهم، وجبر كسرهم، وأخلف لهم ما بذلوا، وضاعف لهم ما عملوا، ويسر لهم أسباب قبوله، وفتح لهم أبواب رضوانه، فجمع لهم أطراف الخير، وجعلهم في شرف قربه وجواره.
والحق أن السلوك إلى رب العالمين هو الشامة الدائمة التي بها يقف الإنسان من ربه على مكانته، متفاعلا ماضيا في طريق الله الذي خطه له، وأرشده إليه، وهداه به.
والسلوك الى الله سبحانه وتعالى ضرب من الخضوع بالغ حد النهاية ناشئ عن استشعار القلب عظمة المعبود. وليس عند القلوب المؤمنة والأرواح الطيبة، والعقول الذاكية: أحلى، ولا ألذ، ولا أطيب، ولا أسر، ولا أنعم من محبة الله، والأنس به، والشوق إلى لقائه.. وكلما كانت المحبة أكمل، وإدراك المحبوب أتم، والقرب منه أوفر، كانت الحلاوة واللذة والسرور والنعيم أقوى..
ولعل من بشائر اجتباء الله سبحانه وتعالى أن هيأ رجالا وضحوا أساليب السلوك هدي القرآن الكريم، وسنة النبي الصادق محمد صلوات الله وسلامه عليه.
وإن من الحقائق التي لا مرية فيها: أن الإنسان لا يأتى له أن يلج باب الله، أو يسير في الطريق إليه.. إلا بالعبودية الخالصة لله وحده لا شريك له.
فإذا ما تمخضت العبودية لله سبحانه، وأصبح الإنسان من عباد الله المخلصين، وحقق بذلك (إياك نعبد وإياك نستعين) فإن الله سبحانه لا يجعل للشيطان عليه من سبيل.
وإذا ما حقق الإنسان العبودية، فإن الله يتولاه بالإمداد بالمعرفة. إنه سبحانه وتعالى يقول عن موسى وفتاه: (فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما).
إنه حقق العبودية، فكان ثمرة ذلك أن يغمره الله بالرحمة، وأن يفيض عليه العلم وليست المعرفة وحدها هي ثمرة التحقق بالعبودية، بل إن للتحقيق بالعبودية ثمارا كثيرة سامية..
ولقد حقق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العبودية كاملة تامة.. لقد حققها في ذروتها.. فكانت صلاته، وكانت نسكه، وكانت حياته بأكملها، وكان موته لله رب العالمين لاشريك له: (قل أن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين).
ولايجهل أحد من المسلمين أن أول متنسك في الإسلام هو سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام.. وقد ترسم كثير من الصحابة الأولين خطاه، واسترشدوا بهداه، فتنسك منهم أبو ذر، وصهيب، وحذيفة، وأبو الدرداء، وأبو هريرة، وعمران الخزاعي، وغيرهم، وكانوا أول الأمر يدعون بالزهاد، أو العباد، أو النساك، أو البكائيين أو الوعاظ، ولم ينكر عليهم هذا أحد.. لا صاحب الشريعة ولا أصحابه، بل أقروهم على خطتهم، وفضلوهم على المستمتعين المتلذذين، وأعترف لهم كثير من الصحابة بكرامات ومعارف، لا تتاح لكافة المسلمين..
ولا يستطيع مؤمن إيمانا صحيحا الاعتراض على هؤلاء، وقد انتهلوا جميع العناصر الأولية لتنسكهم من الكتاب الكريم، والأحاديث القدسية والنبوية والسنة الغراء، فاغترفوا من هذه المنابع السامية: أصول الإيمان، ومبادئ التقوى، وعناصر الذكر، والفكر، وقواعد التطهر الباطني، وقوانين السلوك العملي.. والذي لاشك فيه أن المسلمين الأولين قد طفقوا منذ فجر الإسلام يتأملون في المثل القرآنية العليا، ليتخذوا منها نبراسا، يضيئون به أعماق قلوبهم ليستكشفوا في دخائلها عناصر الأحوال الروحية التي شاهدوها ممثلة في نبيهم، بعد أن ظفرت بالرضى الإلهي العميم.. ولقد ركزوا جهودهم الشخصية في هذا التأمل حتى بلغ عندهم من العمق حدا لم تظفر بمثله كافة المسلمين. وهذا الذي سماه الحسن البصري فيما بعد “علم الخواطر والقلوب”.
ومما لا سبيل الى الريب فيه بأي وجه من الوجوه أن المصدر الأول الذي أرشد المسلمين إلى هذا الصراط السوي، وأنار لهم طريق العروج إلى رب العالمين هو القرآن الكريم والأحاديث القدسية.. وأن المصدر الثاني هو أقوال النبي الجليل صلوات الله عليه وسلامه، وأفعاله الظاهرية، وأحواله الباطنية التي كانوا يرونها ببصائرهم، يستشفونها بقلوبهم، فيتخذون منها مثلهم العليا، ونماذجهم الرفيعة، وشموسهم الساطعة، التي تضئ لهم سبيل الحياة..
ومن هذا يتضح أن السنة المحمدية عند هؤلاء الأتقياء، ليست هي الإحاطة بالأوامر الظاهرية، والأفعال الخارجية وأتباعها فحسب، ولكنها أيضا تطبيق أصول الفضائل الأخلاقية الباطنية..
فالكتاب والسنة وحياة الرسول صلى الله عليه وسلم تطبيق نموذجي للتجربة الدينية بجميع أبعادها ولأهم الأسس التي يقوم عليها التصوف.
وأساليب التصوف الإسلامي تقوم على تربية المريدين على التوبة، والمجاهدة، والزهد، والمحبة، والخشية، والورع، وقطع الهوى. وكل ما يدخل تحت المقامات. فالمقامات أساليب تربوية.
تربية تجعل الإنسان إيجابيا، يعيش في حركة بناءة.
تربية تؤهل الإنسان للعطاء، وتنمي فيه القدرة على مواجهة الصعاب.
تربية تعد الإنسان إعدادا ناضجا لممارسة الحياة بالطريقة التي يرسمها ويخطط أبعادها الإسلام.
تربية تجعل الشخصية الإسلامية شخصية متزنة، لا يطغى على موقفها الإنفعال، ولا يسيطر عليها التفكير المادي، ولا الانحراف الفكري المتأتي من سيولة العقل.
تربية تبني الإنسان على أساس وحدة فكرية، وسلوكية وعاطفية متماسكة على أساس من التنسيق.
تربية تجعل الإنسان يشعر دوما أنه مسؤول عن الإصلاح وفعل الخير.
إن هذه الأساليب تؤكد لنا إن التصوف هو جزء جوهري من الدين الإسلامي. إذ أن الدين يكون ناقصا بدونه، بل يكون ناقصا من جهته السامية –أعني جهة المركز الأساسي-لذلك كانت فروضنا رخيصة، تلك التي تذهب بالصوفية إلى أصل أجنبي “يوناني” أو “هندي” أو “فارسي”.. وهي معارضة بالمصطلحات الصوفية نفسها تلك المصطلحات التي ترتبك باللغة العربية ارتباطا وثيقا..
وإذا كان هناك من تشابه بين الصوفية وما يماثلها من البيئات الأخرى، فتفسير هذا طبيعي لا يحتاج إلى فرض الاستعارة، ذلك أنه مادامت الحقيقة واحدة فإن كل العقائد السنية تتحد في جوهرها، وإن اختلفت فيما تلبسه من صور.
والحق أننا نلاحظ منذ ظهور الإسلام أن الأساليب التي اختص بها متصوفة المسلمين، نشأت في قلب الجماعة الإسلامية نفسها أثناء عكوف المسلمين على تلاوة القرآن و الحديث، وتقرئهما، وتأثرت بما أصاب هذا الجماعة من أحداث، وما حل بالأفراد من نوازل.
ويذكر صاحب التبصير في الدين: ما يمتاز به أهل السنة من غيرهم فيقول: أن سادس ما امتاز به أهل السنة هو التصوب والإشارات ومالهم فيها من الدقائق والحقائق.
فمن القرآن والسنة استمد الصوفية أول ما استمدوا أساليبهم في الأخلاق والسلوك، ورياضاتهم العملية التي قاموا عليها من أجل تحقيق هدفهم من الحياة الصوفية.
وقد بين لنا الطوسي في “اللمع” أن للصوفية تخصيصا بمكارم الأخلاق، والبحث عن معالي الأحوال، وفضائل الأعمال، اقتداء بالنبي وصحابته، ومن تبعهم. وهذا كله موجود علمه في كتاب الله عز وجل.
ونظرة تحليلية إلى التصوف تبين لنا أن الصوفية على اختلافهم يتصورون أساليب للسلوك إلى الله، تبدأ بمجاهدة النفس أخلاقيا وتتدرج الأساليب في مراحل متعددة، تعرف بالمقامات والأحوال، ينتهي السالك من مقاماته وأحواله إلى المعرفة بالله.
فالتصوف الإسلامي بقضه وقضيضه انبثق من القرآن الكريم، والأحاديث القدسية والنبوية. حيث انتهله أربابه من الحياة المحمدية، ظاهرها وباطنها وقد بدأها النبي صلى الله عليه وسلم وسار الصحابة رضوان الله عليهم فيها على نهجهم السامي واقتبسوا من أنواره السماوية المتلألئة، دون أن يشوه جمال ذلك أجنبي أو يدنس نقاءه دخيل لأن الاتجاه إلى السلوك الصوفي له مؤثراته الداخلية البحتة. وهي مؤثرات تتصل بالفرد من الناحية الداخلية، أكثر من أن تتصل بعامل خارجي.
لابد –إذن- من أن يكون الاستعداد الشخصي الفردي الفطري موجودا مهيئا، ويكفي لأن يسلك عمليا هذا الطريق، كلمة، أو فكرة، أو إشارة، أو حادثة من الحوادث، فيأخذ فعلا في سيره نحو الله تعالى: “إني ذاهب إلى ربي”..هذا العزم المصمم الذي يتمثل في هذه الكلمة الكريمة: لابد له من الاستعداد الفطري، الذي لا يغني عنه فلسفة “أفلاطونية” ولا “فيدانتا هندية” ولا “زرادشتية فارسية”.
وقد يكون المتجه إلى التصوف قارئا للأفلاطونية الحديثة، أو لا يكون، وقد يكون على علم بعقائد “الهند” أو لا يكون. فالمتخصص في الأفلاطونية الحديثة، لا يفيده مخصصه في هذا أن يكون صوفيا وكذلك الأمر في المتخصص في عقائد الهند.
وقد قرأ الإمام الغزالي كتب الصوفية أنفسهم، ويحدثنا بذلك فيقول: “فابتدأت بتحصيل علمهم من مطالعة كتبهم مثل “قوت القلوب” لأبي طالب المكي، رحمه الله، وكتب الحارث المحاسبي، والمتفرقات المأثورة عن الجنيد والشبلي وأبي يزيد البسطامي –قدس الله أرواحهم- وغير ذلك كن كلام مشايخهم، حتى اطلعت على كنه مقاصدهم العلمية، وحصلت ما يمكن أن يحصل عن طريقهم بالتعليم والسماع”.
ويعلق الدكتور عبد الحليم محمود على كلام الغزالي فيقول: ولكن ذلك لم يجعل منه صوفيا، ولم يكن الغزالي بهذه الكتب ولا بمطالعته لفلسفة النونان، ودراسته لها دراسة عميقة صوفيا.. ولكنه تبين أن أخص خواصهم –على حد تعبيره- ما لا يمكن الوصول إليه بالتعليم، بل بالذوق والحال وتبدل الصفات.
فليس التصوف ثقافة كسبية تتأثر بهذا الاتجاه أو ذاك، وإنما هو ذوق ومشاهدة، يصل الإنسان إليهما عن طريق الخلوة، والرياضة، والمجاهدة والاشتياق بتزكية النفس، وتهذيب الأخلاق، وتصفية القلب لذكر الله تعالى.
توالت حركة التصوف بعد الصحابة عند التابعين، في كثير من البساطة بحيث كانت مقوماتها الذاتية هي: التأمل في آيات القرآن، ومحاولة استكشاف أسرارها العميقة، واقتناص مراميها البعيدة، والزهادة، وكبح جماح النفس، والاعتكاف والتنفل والتهجد. وكان المتصوفة في أول نشأتهم متفرقين، ولكنهم لم يلبثوا أن شعروا بالحاجة إلى إجتماعهم، وتأليفهم وحدة قوية، فتعارفوا واجتمعوا فريقين: أحدهما في البصرة، وثانيهما في الكوفة، وكون كل فريق منهما مدرسة لها تعاليمها وآراؤها التي تتفق مع ميوله الفطرية.
وأن الباحث يجد أن الصوفية في القرن الثالث الهجري، اتجهوا إلى الكلام عن معاني لم تكن معروفة من قبل، فتكلموا عن الأخلاق والنفس، والسلوك، محددين طريقا إلى الله، يترقى السالك له، فيما يعرف بالمقامات والأحوال، وعن المعرفة ومناهجها.. ووضعوا القواعد لهذا لكه، كما حددوا رسوما عملية معينة لطريقتهم.
ويمكن أن يؤكد الدارس للتصوف أن القرن الثالث هو بداية تكون علم التصوف بمعناه الدقيق. واستمر هذا التصوف كذلك في القرن الرابع، بحيث يمكن أن نعتبر تصوف هذين القرنين تصوفا إسلاميا ناضجا اكتملت له كل مقوماته.. حيث دخل التصوف دور المواجد، والكشف، والأذواق، وهذا الدور يقع في القرنين الثالث والرابع، اللذين يمثلان العصر الذهبي للتصوف الإسلامي في أرقى وأصفى مراتبه.
وقد أصبح التصوف منذ القرن الثالث مميزا على علم الفقه من ناحية الموضوع والمنهج والغاية.. ولاشك أنه كان لحركة تدوين العلوم الشرعية التي سبقت تدوين التصوف أثر في ذلك، على نحو ما يقول ابن خلدون: “فلما كتبت العلوم ودونت، وألف الفقهاء في الفقه وأصوله، والكلام والتفسير وغير ذلك، كتب رجال من أهل هذه الطريقة في طريقهم، فمنهم من كتب في الورع ومحاسبة النفس على الاقتداء في الأخذ والترك..”
ويصف ابن خلدون المقابلة بين علمي الفقه والتصوف قائلا: “وصار علم الشريعة على سنفثن: صنف مخصوص بالفقهاء وأهل الفتيا، وهو الأحكام العامة في العبادات والعادات والمعاملات. وصنف مخصوص بالقوم –الصوفية- في القيام بهذه المجاهدة ومحاسبة النفس عليها، والكلام في الأذواق، والمواجد العارضة في طريقها، وكيفية الترقي فيها من ذوق إلى ذوق، وشرح الاصطلاحات التي تدور بينهم في ذلك.
ويذكر الدكتور أبو العلا عفيفي: أنه “لولا التصوف لكان الإسلام كما فهمه المتزمتون من الفقهاء والمتكلمين والفلاسفة، ديننا خالنا من الروحانية العميقة، ومن العاطفة وكانت عباداته ومعاملاته مجموعة جامدة من القواعد والأشكال والأوضاع، ومعتقداته مجموعة من التجريدات، أقل ما يقال عنها أنها تباعد بين العبد وربه، بدلا من أن تقربه إليه، وتورث صاحبها الشك والحيرة والقلق، بدلا من الطمأنينة واليقين”.
والشيخ مصطفى عبد الرزاق يعلق على مادة التصوف، في دائرة المعارف الإسلامية فيقول: “ولما نشأ البحث في العقائد والتماس الإيمان من طريق النظر أو النصوص المقدسة، وتوجهت همم المسلمين إلى التماس المعرفة على أساليب المتكلمين أسبح الكمال الديني التماس الإيمان والمعرفة من طريق التصفية والمكاشفة، وأسبح عبارة عن بيان هذه الطريقة وسلوكها”.
ويرى أهل البحث والدراسة: أن التصوف ليس أسلوبا من الأساليب يحيا الصوفي بمقتضاه، وحسب بل هو في الوقت نفسه وجنة نظر خاصة تحدد موقف العبد من ربه أولا، ومن نفسه ثانيا، ومن العالم وكل ما فيه ومن فيه آخر الأمر.. فالصوفية لم يشاركوا عامة المسلمين في نظرتهم إلى الدنيا، ولم يشاركوا الفقهاء أو المتكلمين في نظرتهم إلى الدين، ولم يشاركوا الفلاسفة في نظرتهم إلى الله والإنسان والعالم. ولهذا جاء التصوف الإسلامي ثورة شاملة على هؤلاء جميعا.
والتصوف الإسلامي ينفرد عن سائر مظاهر الفكر الإنساني بعامة، والإسلامي بخاصة، حيث أن التصوف تجربة ذاتية ومنهجه الذوق. فالتصوف في جوهره تجربة روحية تخص الصوفي الذي يعانيها ويكابدها، مصدر هذه المعاناة إرادة عارمة من الصوفي أن يتصل بالله. ولما كانت هذه الأخوال تخص من يعانيها فضلا عن أنها لا تخضع لحكم العقل ومقولاته. فإنه يحق للصوفية أن يعترضوا على كل من يحاول أن يزن تجاربهم وتعبيراتهم عنها بميزان العقل، لأن العقل وقوانينه مشترك بين الناس جميعا، أما التجارب الصوفية فلا تخص غيرهم. وإذا كانت التجربة الصوفية من خلال الأساليب حال ذاتية فإنه يلزم عن ذلك نتيجتان:
أن تتفاوت التجارب وفقا لمقام كل صوفي في الطريق، ووفقا للاستعداد الروحي لكل منهم، ومن ثم تختلف تعبيراتهم، وأن لا تتفق أحوالهم.
ولكن هذا لا ينفي اشتراك القوم في أصول الأساليب كالزهد والرجاء وغيرها من المقامات، وكالمحبة والأنس والشهود وغير ذلك من الأحوال. ونجد أن القوم قد اتفقوا على مصطلحات معينة يطلقونها على مسائلهم ووارداتهم، وعلى منهج في المعرفة ذي ثلاث شعب حسية وعقلية وقلبية.
وإذا كانت النتيجة الأولى هي تفاوت التجارب وفقا لمقام كل صوفي، فإن النتيجة الثانية هي تفاوت أحوال الصوفي الواحد في أوقاته المختلفة وفقا لاستعداده وحالته النفسية وترقيه في الطريق.. وإذا كانت نقطة البدء في أي نشاط عقلي –كالفلسفة- أهنا أفكر وأنا أشك باعتبار الشك مظهرا للتفكير، فإن منطلق التجربة الروحية التي هي جوهر التصوف “أنا أريد”.
فالتصوف هو المظهر الروحي الديني الحقيقي عند المسلمين، لأنه المرآة التي ينعكس على صفحتها الحياة الروحية الإسلامية في أخص مظاهرها.. فإذا أردنا أن نبحث عن العاطفة الدينية الإسلامية في صفائها ونقائها وعنفها وحرارتها وجدناها عند الصوفية.. وإذا أردنا أن نعرف شيئا عن الصلة الروحية بين المسلم وربه، كيف يصور هذه الصلة، وكيف يجاهد طول حياته في توكيدها وتدعيمها، وكيف يضحي بكل عزيز لديه –بما في ذلك نفسه- محافظة وغيرة عليها، وجب أن نقرأ سير الصوفية المسلمين ونتدبر أقوالهم.
وإذا كانت أمم الأرض تعمل بكل ما تملك من إمكانات على أن تظل المجتمعات الإسلامية بعيدة عن حركة العام والحياة، فإن معنى ذلك أن مجتمعات هذه الأمة وقعت فريسة لتكالب مسعور ومخطط مرعب.
ونحن إذا تأملنا حال الأمة الإسلامية وجدنا أنها من وجهة نظرنا محاصرة بين غربتين: غربة زمان وغربة مكان.
أما غربة الزمان فهي بعد الأمة عن ماض حضاري مشرق لم تعد تربها به عوامل الثقافة الفاعلة أو البانية.
وأما غربة المكان فهي بعد الأمة عن واقع حضاري معاصر تجهل عنه كل مما مثل فجوات حضارية كبرى.
ولا تستطيع أن تخرج من حصار عربة الزمان وعربة المكان إلا من خلال استثمار الأساليب الصوفية.
فالأساليب الصوفية حرصت على إحاطة المريدين بمناعات عقدية وخلقية وتربوية تحول دون أن يتأثر السالكون بالمغريات أو التيارات التي تنال من كرامتهم أو تحط من مكانتهم.
كما زود رجال الطرق الصوفية المريدين بمضادات ذات قيم فعالة تعالج ما قد يبتلى به المريدون من إصابات سلوكية تؤدي إلى التأخر. ذلك أن في الإنسان “قابلية التأثر” وهو يملك القدرة على التأثير. فكان لابد من صيانة قابلية التأثر “لدى الإنسان لكي لتكون مجالا رحبا للمؤثرات الخارجية المنافية. ولأن الإنسان يملك القدرة على التأثير فيما حوله أصبح من الضروري أن يظل هذا الإنسان سليما.
فالنظرة الشمولية التي ترتكز عليها أساليب التصوف الإسلامي من تربية المريدين تقرر أن هذا السلوك ينعكس لا على حياة الإنسان نفسه فحسب بل على الموجودات كافة بشكل مباشر أو غير مباشر إذ ما من طاقة إلا ولها أثر ولذلك اهتم المنهج الصوفي في أساليبه بالسلوك باعتباره العامل الحاسم.
وتحقق السلوك إنما يتم عن طريق وجود القدوة ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم حافز لمن يريد السلوك الحق.
وأن وجود نموذج أخلاقي بشري هو أعظم حافز لمن يريد أن يبوى للأخلاق في نفسه محلا كريما أن يبذل جهده وأن يظل على جهاده لأن أمله في تحقيق غايته ليس مستحيلا كما أنه ليس بعيدا.
والتهمة في عدم تحقيق هذه الغاية لم تعد في استحالتها أو بعدها، ولكن في قصور الجهد المبذول من أجلها. وذلك يدفعه إلى بذل المزيد من الجهد وسواء حقق في نفسه المثل الأعلى أو قاربه، فإن إنسانا يجعل هذا غايته لهو إنسان عالي الهمة، عظيم الخير والبر. وكل إنسان يستطيع أن يحقق في نفسه قدرا أكبر من التأسي بهؤلاء المثل البشرية العالية يصبح بدوره أسوة وقدوة لمن لم يبلغ مبلغه، وتصبح هناك سلسلة من الأسوة الحسنة تتفاوت درجاتها في مراقي الكمال.
ومن المعروف عند الصوفية: أن الطرق شتى وطريق الحق مفردة والسالكون طريق الحق أفراد. ومع أن طريق الحق مفردة فإنه تختلف وجوهه باختلاف أحوال سالكيها.
ولا يخفى أن الأساليب الصوفية تركز على بناء الذات الإنسانية من داخلها لأن أنماط السلوك إنما هي تعبير عن محتوى الإنسان الداخلي. فإن لم تشكل الذات الداخلية وتبنى بناء خيرا وسليما لا يمكن أن يكون البناء الخارجي إلا هيكلا خاويا.
والأساليب الصوفية تريد أن تجعل سلوك الإنسان المؤمن قائما على أساس الاختيار اليقظ الواعي بعيدا عن السعادة الآلية الني تجعل من السلوك الإنساني سلوكا رتيبا لا يعبر عن وعي الإنسان وارتباطه بخالقه.
وكم هو سهل هدم الموقف الإنساني والانسحاب من الفعل مهما يكون خيرا وضخما عندما يبني هذا الفعل على أساس من الآلية والاعتياد بعيدا عن الوعي والقناعة والاتجاه الذاتي اليقظ لذلك حرص التصوف الإسلامي على تثبيت قواعد الفعل في أعماق الذات الإنسانية، ليضمن الاستمرار على فعل الخير وبناء الحياة الإنسانية.
والأساليب الصوفية لم تكتف برسم المنهج السلوكي وبيان الدافع الذي ينبغي أن يؤدي إليه ولكنها عملت على تهيئة النفوس وإعدادها أعدادا عمليا لتتحول المبادئ النظرية إلى واقع عملي. وبالتالي ليرتبط الدافع بالسلوك ذلك الارتباط المبتغى.
ومن النتائج الناجحة لتعميم الأساليب الصوفية:
أولا: التركيز على تقوية التصديق بالمفاهيم المتعلقة بالعقيدة والعمل لتعميق تلك المفاهيم حتى تبلغ مرحلة السيطرة على النفس فتفيض الجوارح عندئذ بالسلوك.
ثانيا: تربية المسلم على الشعور المستديم بالحضور الإلهي في كل ما يأتيه من الأعمال وذلك بالإحساس الداخلي بأن كل إبقاء لفعل أو انتهاء عن فعل إنما هو تحقيق لمعنى الطاعة المطلقة لله تعالى.
ثالثا: الحث على العلم والدعوة إليه.
وإذا تأملنا هذه النتائج فقد نصل إلى أنها عملت على نشر الإسلام في مشارق كثير من بقاع الأرض و لازالت تعمل على تحصين مجتمعات الأمة الإسلامية ضد تيارات تكيد للمسلمين وأن اهتماما واسعا بالتصوف الإسلامي وتعميما لهذه الأساليب القائمة على التربية سوف يضع الأمة الإسلامية على عتبات مجد مشرق.